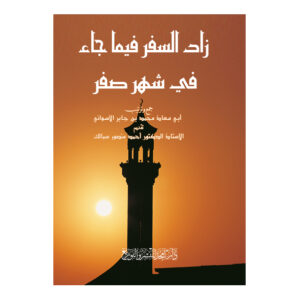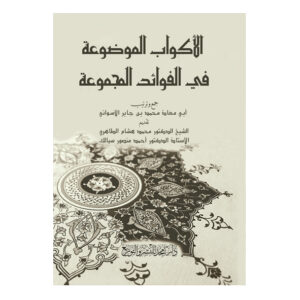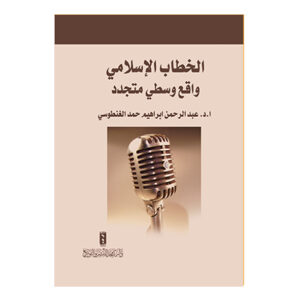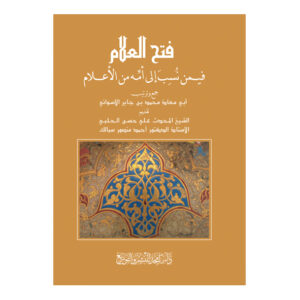فقة الاخلاق في الشرائع السماوية
$35.00
اسم المؤلف: د.حميدة الأعرجي
سنة الطبع: 2019
عدد الصفحات:572
9789957997830 ISBN
دار امجد للنشر والتوزيع
نوع الكتاب
ورقي
إن صفات الأفعال الأخلاقية ثابتة في عالم الوجود، سواء وُجِد الإنسان أم لم يوجد على هذه الأرض، ولكنها لم تُدرس كعلم يُعلّم ويُتعلّم إلّا على يد فلاسفة اليونان، الذين نظّروا لها من أجل سعادة الإنسان والرقي به إلى العيش في مجتمع منظم وسعيد، واستفاد فلاسفة الإسلام ومتكلموه من هذا العلم بعد عصر الترجمة، واستطاعوا أنْ ينهضوا به بعد أنْ أضافوا إليه تعاليم السماء، على الرغم من أنَّ بعضهم نقل هذا العلم نقلًا حرفيًا وآمن بهذا النقل، الذي يوحي إلى الجبر في أفعال الإنسان، إذ بدا ذلك واضحًا من خلال تعريفاتهم للأخلاق.
وقد تباينت الآراء بين أعلام الفلاسفة والمتكلمين في ماهيَّة الحسن والقبح العقليين، لأنّ بعضهم نظر إلى صفات الأفعال بما يعرضها من الأعراض -من حيث اللّذة والألم والملائمة والمنافرة والأمر والنهي… إلخ- ولم ينظروا إلى الأفعال بما هي هي مجردة عن كل عَرَض أو غَرَض.. ومن هنا كان الخلط بين الثابت والمتغير؛ لأنَّ الذي يتغير وتتغير بتبعه العادات والتقاليد لا صلة له بالأخلاق وثباتها.
هناك تشابه إلى حدٍ كبير قد يصل إلى المطابقة -أحيانًا- بين أحكام الفقه في الشرائع السماوية، فما هو حسن أمرت به، وما هو قبيح نهت عنه، على الرغم من التحريف الذي طال كتابي التوراة والإنجيل، إلّا أنَّ هناك من تفاصيل الأحكام ما ميَّز هذه الشرائع بعضها عن بعض. فقد امتازت أحكام الشريعة اليهودية بالشدة والحزم والاستيفاء الكامل، سواء في فقه الفضائل أو في فقه الرذائل، لأنها اهتمت بظاهر هذه الأحكام أكثر من اهتمامها بالجانب الروحي لها، وهذا على عكس ما ميَّز الشريعة النصرانية، التي غلّبت الجانب الروحي الباطني العرفاني على الجانب الظاهري في فقه الفضائل، وغلّبت العفو والمسامحة المفرطة في فقه الرذائل.
Related products
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني 542 هـ – 1144 م – دراسة في المنهج و الموارد
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي
التاريخ والشريعة والفقة الاسلامي